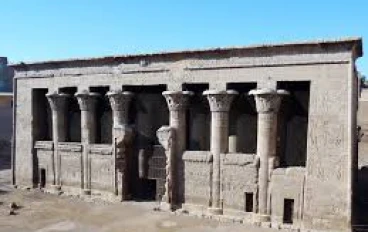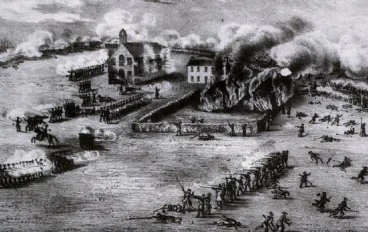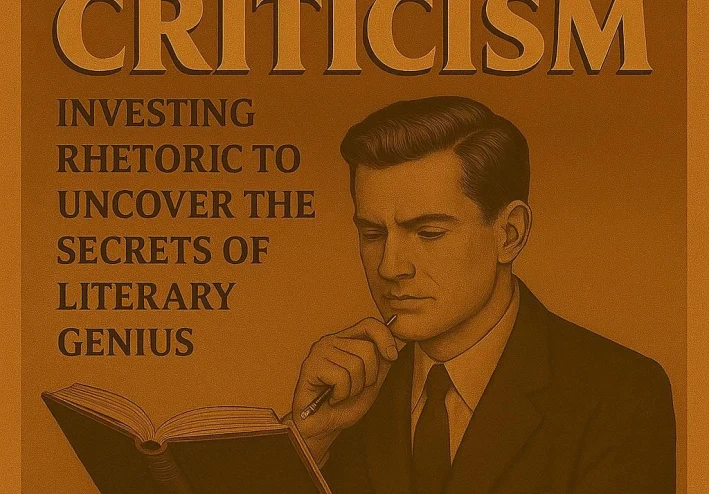
جوهر النقد: استثمار البلاغة لكشف أسرار العبقرية الأدبية
جوهر النقد: استثمار البلاغة لكشف أسرار العبقرية الأدبية
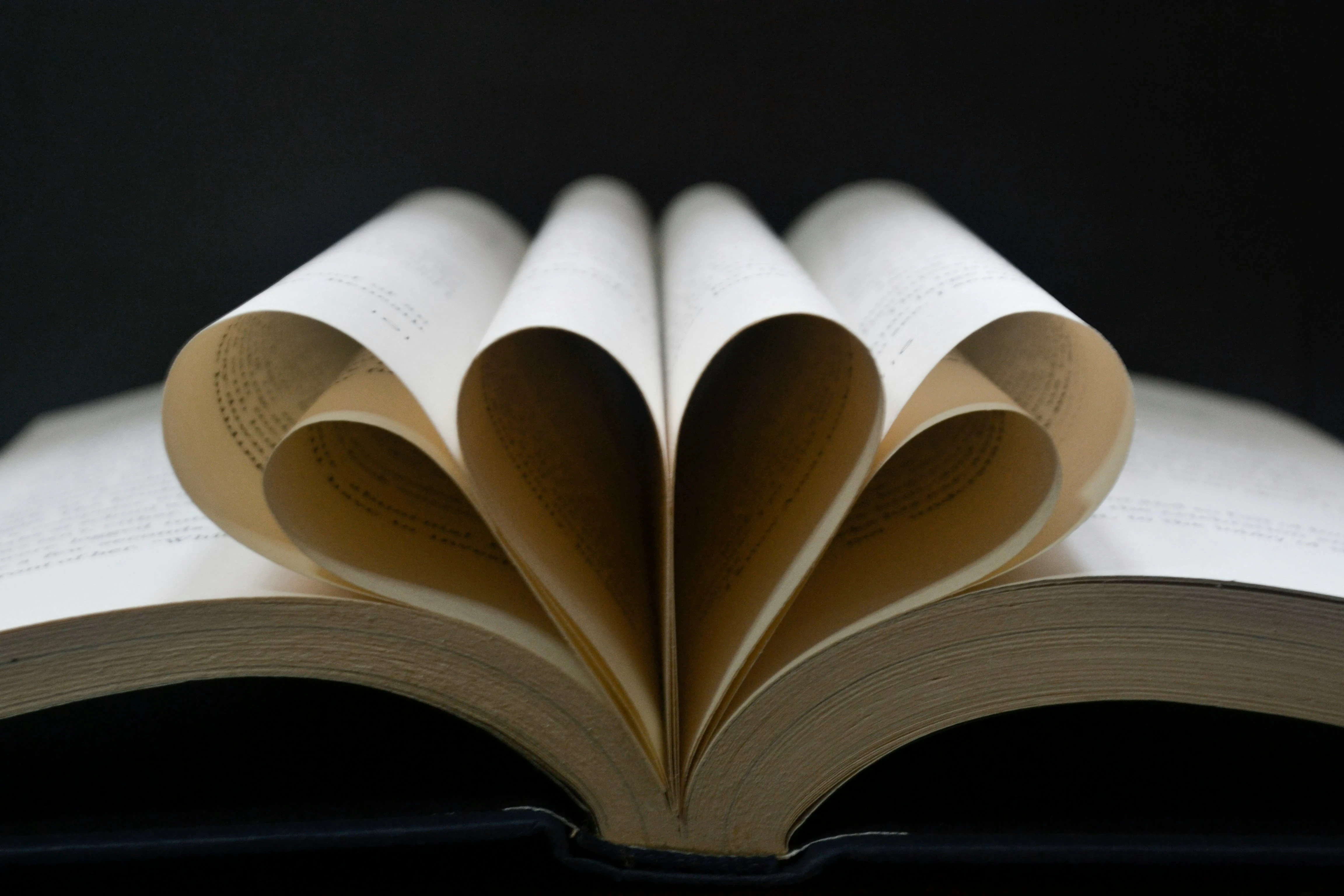
نماذج الأدب تأتي اولاً ثم يكون النقد والبلاغة خلال مدارسة هذه النصوص، ومحاولة سبر أبعادها، وإدراك سماتها الفنية، وعلاقاتها الداخلية التي تجلى بنائها، مع ما قد يكمون من تفسير وشرح، سواء تعددت مستويات ذلك الشرح أو لم تتعدد.
إذن فالأدب بما له من خصائص فنية هو موضوع النقد والبلاغة. إذا صح ما سبق لم ينحو بعضنا باللائمة على البلاغة العربية، بل ويطالب بهجرها لأنها أفسدت الذوق، وجففت ينابيع الأدب، وخرجت به إلى الصنعة العقيمة ؟
مع أن البلاغة تذوق جمالي ينبغي أن يدخل في جملة ما نتعامل به من وسائل مع النصوص، عندما تقوم النتاج الأدبي والفني.
ولكن ربما كانت النظرة التجزيئية إلى تطور الفكر البلاغي والنقدي عند العرب هي التي دعت إلى ذلك الاتجاه ... لا سيما في محاولة الفصل بين البلاغة والنقد، وخلال عصور الأدب المختلفة لم يكن هناك فصل بين النقد والبلاغة، هكذا مر العصر الجاهلي ، وتلاه عصر صدر الإسلام، فالعصر الأموي ، وفترة من العصر العباسي دون أن يشير دارسوا الأدب أثناء تناولهم للنصوص أنهم يبحثون في النقد الأدبي أو البلاغة وربما كانت دراساتهم وتحليلاتهم للنصوص من قبيل البحث في بلاغتها، من وجهة نظرهم، وهم يقصدون بذلك البحث محاولة التفسير والشرح وبيان مدى الإصابة أو الإخفاق، وما حققه مبدع النص من غايات وأهداف وفق المثل الفنية، وهكذا يحاولون دراسة النصوص والتمييز بين أساليبها المختلفة. وأقول يحالون، خاضعين في ذلك للذوق ..، الذي تمرس بالنصوص وتثقف بالتقاليد الفنية المرعية آنذاك.
كذلك كان الجاحظ (ت 255هـ) في البيان والتبيين وابن المعتز (ت 296هـ) في " البديع"، بل وعبدالقاهر الجرجاني (ت 471هـ) في "دلائل الإعجاز"، وأسرار البلاغة بصفة عامة، وهؤلاء هم الثلاثة الذين ينسب إليهم بعض المفكرين نشأة البلاغة العربية، ولست بذلك أسوى بين هؤلاء الثلاثة في درجة رقي منهج كل منهم، وإنما فقط أشير إليهم بصفة عامة، ومن حيث نسبة ونشأة البلاغة إلى كل منهم.
وربما كان انتشار فكرة تقرير الأسس والتقسيمات هو ما حدى ببعض الدارسين إلى تخصيص البلاغة بالتقسيمات والمناهج التعليمية التقريرية منذ أبي هلال العسكري كما يرى الدكتور محمد مندور، عندما نسب تحول النقد إلى بلاغة لأبي هلال في " الصناعتين"، وكما يرى ابن خلدون في نسبة نشأة البلاغة إلى السكاكي ( 626هـ) في كتابه" مفتاح العلوم" حيث ظهرت أقسام المعاني والبيان والبديع منضبطة مقننة، في صورة علمية، بعد أن عرض لكثير منها قبل ذلك عبدالقاهر ثم الزمخشري في صورة قوامها النظرة الذوقية المثقفة التي تمرست بدراسة النصوص، ووعت تقاليد العرب في الإبداع ونهلت من الثقافات المختلفة واحتكت احتكاكاً قوياً بضروب الإبداع والإعجاز في القرآن الكريم.
وإذا كانت تقسيمات أبي هلال العسكري ، أو تقسيمات السكاكي أو غيرهما من المفكرين العرب الذين سبقوهم في هذا المجال قد جاءت بناء على مدارس للنصوص واستيعاب لمقارنات وموازنات بينها قاموا هم بها، أو قام غيرهم بها في مجال الأدب العربي ونصوصه، فلماذا يعاب عليهم ذلك، طالما أنهم يتغيون بها وصول المبدعين إلى أفضل مستوى فني ؟ وقد يكون في ذلك تقييد للمبدع، وتحجيم لمقدرته، وقولبة لفكره، لكننا نعتقد أن هذه الحدود هي الحد الأدنى الذي يجب ألا يهبط دونه أحد، بدليل أن من يبدع محققاً جمالاً فنياً متجاوزاً به هذه الحدود والأعراف لم يكن يعاب عليه ذلك، بل يذكر له ويحمد له ويثنون عليه به، وإن وجد من يعارضه، كالعهد بكل جديد وقت حدوثه.
وليس فكرنا العربي بلجوئه إلى التقسيمات بدعاً بين آداب الدنيا في هذا الصدد، فها هو ذا أرسطو أبو النقد الأدبي عند اليونان ، يلجأ إلى التقسيمات في القرن الثالث ق .م وهو من يعزى إليه التأثير في آداب العالم أجمع بما قننه للنقد الأدبي سواء في رسالته عن الشعر أو كتابه عن الخطابة.
وكذلك فعل بوالو في فرنسا حين قنن للألوان الأدبية المختلفة في " الفن الشعري" وهو مشرع النظرية الكلاسيكية في القرن السابع عشر، وقد تأثر بأرسطو.
بل إن قدامة بن جعفر قد تأثر هو أيضاً بأرسطو وقدم في كتابه" نقد الشعر" تقنينات، فلم لم يصنف ضمن البلاغيين فقط إذا كانت التقسيمات والتقريرية هي أساس تصنيف المفكرين إلى نقاد وبلاغيين ؟
إذن لم يكن السكاكي أو العسكري بدعا فيما فعلا، بل ربما كان هذا اللون من الفكر بحاجة إلى تقنين السكاكي وتقريريته لينضبط في وقت تهددت السليقة العربية بفساد الأذواق، وتضاؤل الطبع في نفوس العرب نتيجة عوامل عدة منها امتزاج العرب بالشعوب المغلوبة، والصراعات الداخلية والانقسامات، وتربص أعداء العرب والمسلمين بهم من طيبيين وتتر، وما صحب ذلك من ضياع فكري، وحمود امتد منذ القرن السادس الهجري حتى القرن الثاني عشر تقريباً، حيث طغت فكرة التلخيصات وشروح التلخيصات، ودار هذا الفكر في دائرة مغلقة ضيقة، وكان المفروض أن من جاءوا بعد السكاكي لا يسجنون أنفسهم داخل هذه الدائرة، وهو ما تنبه إليه بعض من يتصدون لدراسة البلاغة في العصر الحاضر على تفاوت في درجة المحاولة.
وربما كان وجود بعض النظرات الجزئية كفكرة بيت القصيد مثلاً في الدراسات الأدبية قبل العصر الحديث، أو المقارنات الجزئية المحدودة هو ماحدى ببعض الدارسين إلى الربط بين ذلك وبين مفهوم البلاغة، إذ يخصصونها بالبحث في مظاهر الجمال الحسي والمعنوي في المفردات والجمل، دون البحث في القيمة الجمالية للنص الأدبي المتكامل التي يختص بها النقد الأدبي في نظر هؤلاء أو يربطون بين هذا الفهم الذي يفصل بين البلاغة والنقد، وبين عدم وجود نظريات نقدية بالمفهوم الحديث في مجال دراسة الأدب قبل العصرالحديث.. وقد يكون لهم بعض الحق في ذلك، ولكن التعميم هنا جائر ظالم، لأن هناك من البلاغيين والنقاد العرب قبل العصر الحديث من اهتم بالدعوة إلى الرؤية الكلية للنص مثلاً، ووجوب توثق الاتصال بين أجزاء القصيدة الواحدة، بل وتواتر ذلك بينهم، بصورة أو بأخرى – وأكرر بصورة أو بأخرى – فها هو ذا ابن طباطبا العلوي الأصبهاني المتوفي سنة 322هـ في كتابه" عيار الشعر" ينتبه إلى فكرة الوحدة في القصيدة ، وهو بذلك ينمي ويطور فكرة حسن التخلص من غرض إلى غرض في القصيدة التي دعا إليها سابقوه، حتى إذا جاء ابن رشيق (المتوفي سنة 462هـ) في كتابه العمدة في صناعة الشعر يدلل على فكرة حسن الخروج من الغزل إلى ما يليه، باقتباس نص للحاتمي من القرن الرابع الهجري، حيث ينبه هذا الأخير إلى أن القصيدة بنية عضوية تتلاحم أجزاؤها حتى كأنها بيت واحد وفكرة واحدة.. وأرجو ألا يفهم من ذلك تناظر رأى القدماء واتجاه المحدثين ولكنني أزعم أن فكرة الوحدة كانت معروفة موجودة، وإن لم توظف في الأدب كما ينبغي.
والعجيب أن فكرة الفصل بين البلاغة والنقد تجد من يدعو إليها أو يحاول تبريرها بدعوى البحث في نشأة البلاغة والنقد الأدبي وأيهما الأصل وأيهما الفرع، وينتهي إلى أن النقد هو الأصل والبلاغة فرع وتابعة له، وما أغنانا عن البحث في النشأة، إنما المرجو هو محاولة الكشف عن قيمة تراثنا وإبراز استمراريته واطرادها من منظور الأصالة والمعاصرة، طالما أن فيه نفعاص، وليست جهود عبدالقاهر الجرجاني مثلا ومنهجه في دراسة العلاقات في النظم كأساس لتقويم النص والكشف عن أبعاد المعنى المتضمن بخافية على دارس تراثنا، حيث إن اتجاه عبدالقاهر هذا هو ما تحاول النظرية البنائية في النقد اليوم أن تحققه في بعض جوانبها.