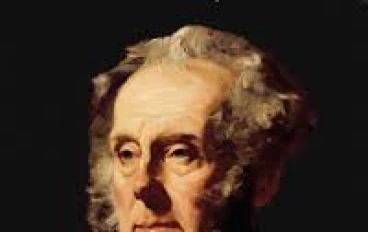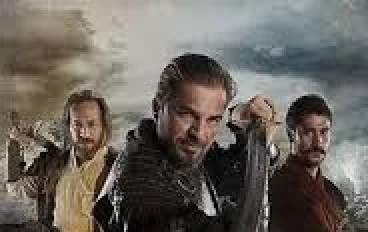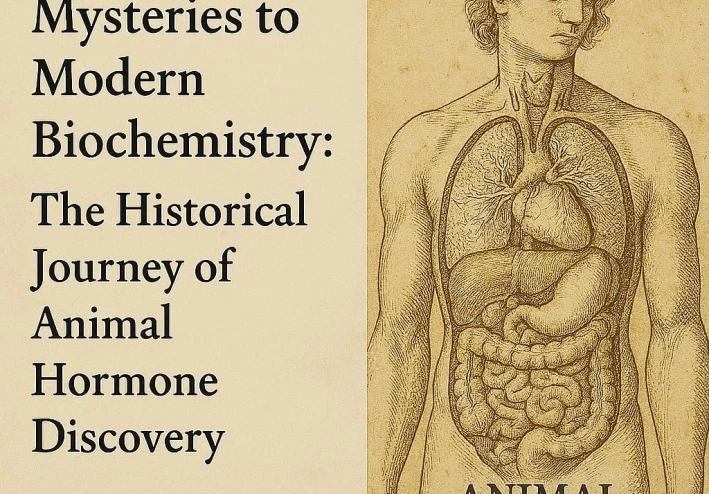
من الأسرار القديمة إلى الكيمياء الحيوية الحديثة: الرحلة التاريخية لاكتشاف الهرمونات الحيوانية
من الأسرار القديمة إلى الكيمياء الحيوية الحديثة: الرحلة التاريخية لاكتشاف الهرمونات الحيوانية
لا أحد يعرف بالضبط التاريخ القديم لاكتشاف الغدد الصماء المنتجة للهرمونات الحيوانية، ومع ذلك فإن طبيعة المادة الهرمونية وتركيبها الكيميائي عرفت منذ بداية القرن العشرين فقط. فحتى عام 1850م كنا لا نعرف شيئا عن الهرمونات، حتى جاء العالم الجراح بيرتهولد الألماني في عام 1849م وأجرى تجربة غريبة للغاية.
فقد أحضر ستة من ذكور الطيور (حمام) وقسمها إلى ثلاثة مجاميع. المجموعتان الأولى والثانية ، أزال منهما الخصى كانت تغرد في الماضي، قد اختفى منها الغناء والتغريد الذي كانت تقوم به لجذب الإناث. كما اختفى منها ريش العرف الموجود على الرأس ، وبدأ يتساقط . كذلك أصيبت هذه الذكور" المخصية" (التي أزيل عنها الخصى) بتغييرات سلوكية واضحة. فبدأت لا تدافع عن أعشاشها كما كانت تفعل من قبل ، وكأنها تحولت إلى أفراد أنثوية.
وبهذه الطريقة أثبت بيرتهولد أن وجود الخصيتين كان ضرورياً لتأكيد صفات الذكورة في هذه الطيور. أما المجموعة الثالثة من الطيور، فقد أزال منها الخصى، ولكنه أعاد زراعتها في مكان آخر داخل البطن بدلا من مكانها الأصلي . وفوجئ العالم بأن صفات الذكورة لم تختف منها وبقيت على حالها.
وتؤكد هذه التجربة على أن بعض أعضاء الكائن الحي الداخلية قادرة على التحكم في صفاته المختلفة (ربما) بسبب قدرة هذه الأعضاء على إفراز مواد كيميائية معينة (هرمونات) لا تتحكم في صفات الذكورة والأنوثة فحسب، بل أيضا في صفات وسلوك الكائن الحي كله.. فهي تتحكم في نموه وحياته ومرضه، ولربما في إصابتهت بالشيخوخة ومماته أيضا.
وفي عام 1775م اكتشف دوبسون طبيعة المادة الموجودة في بول بعض المرضى الذين كانوا يعانون من أعراض الغيبوبة (مرضى داء السكري) وذكر أن هذه المادة عبارة عن مادة سكرية ( سكر العنب). ثم مرت مائة عام على هذا الاكتشاف عندما لاحظ العالمان الألمانيان فون ماييرنج ومينوكوفسكي في العام 1889م ملاحظات علمية بسيطة أدت إلى فتح الباب على مصراعيه في تجاربهما من اجل دراسة أهمية غدة البنكرياس في عمليات هضم الطعام. فقد توقعا أن إزالة هذه الغدد فمن الحيوانات لا تسبب موتها، بل تجعلها ببساطة غير قادرة على هضم الطعام بسبب انعدام الخمائر التي تفرزها. ولكن جاءت نتيجة تجربتهما مخيبة للآمال. فلقد ماتت الكلاب بعد ساعات قليلة من إجراء العملية الجراحية.. إلا أنه قبل موتها اكتشف العالمان ملاحظات بسيطة عابرة كانت بمثابة المفتاح الذي فتح باب أسرار علمية وطبية جديدة كان مغلقاً من قبل. فلقد لاحظا كثرة كميات البول التي أفرزتها الحيوانات بعد استئصال البنكرياس منها، مقارنة مع الحيوانات السليمة. كما لاحظا في نفس الوقت وجود أعداد كبيرة من حشرات النمل والذباب التي كانت تحوم حول أماكن البول داخل حظائر الكلاب. وكان السؤال البديهي الذي طرحه العالمان الألمانيان هو: لماذا تجمعت الحشرات بأعداد هائلة داخل حظائر الكلاب التي أزيلت منها غدد البنكرياس ؟ وللإجابة على هذا السؤال قرر القيام بتحليل عينات البول للتعرف على هذه المادة الجاذبة. وكانت لهما مفاجأة عندما اتضح أنها سكر العنب البسيط (سكر جلوكوز) الذي وجد بكميات كبيرة في بول الكلاب التي استئصلت غددها البنكرياسية . وعندما نشر العالمان نتائجهما هذه، قوبلت بسخرية وانتقاد شديدين من الأوساط العلمية ومن قبل علماء بارزين لم يصدقوا أن للبنكرياس علاقة بظاهرة احتواء البول على السكر. بيد أن هذا الاكتشاف العابر كان من أهم الخطوات المؤدية إلى اكتشاف السكر، وإلى اكتشاف طبيعة الهرمونات التي تنظم عملية حرق السكر في الجسم.
بعد هذا الاكتشاف المثير زاد اهتمام العلماء بمرض السكر، وبدأت نتائج الدراسات القديمة على البنكرياس التي لم يهتم بها العلماء قبلاً تجد طريقها إلى قائمة اهتمامات علماء القرن التاسع عشر. فمن هذه الدراسات القديمة مثلاً واحدة أجريت قبل عشرين سنة منذ اكتشاف علاقة البنكرياس بالبول السكري (أي في العام 1867م) ، ونشرها العالم بول لانجرهانز الذي كان أول من وصف بدقة شكل وتركيب مجموعة صغيرة من الخلايا الإفرازية الموجودة في قطاع غدة البنكرياس. وقد اطلق على هذه الخلايا اسمه، وصارت معروفة في الأوساط العلمية باسم " جزر لانجرهانز" وكان هذا الباحث أول من اقترح أن هذه الخلايا قد تكون المسئول عن إنتاج مادة كيميائية مجهولة، في غيابها يظهر السكر في البول ويتكون مما يعرف بالبول السكري . وبعد مرور نحو نصف قرن من الزمان على نشر هذه النتائج، تراكمت عشرات الأدلة والبراهين تؤكد جميعها أن سبب البول السكري هو قلة إفراز مادة كيميائية معينة تنتجها مجموعة خاصة من خلايا جزر لانجرهانز تعرف باسم خلايا " بيتا" ولقد شجعت هذه النتائج العلماء في جميع أنحاء العالم على بذل الجهود لمعرفة طبيعة هذه المادة المجهولة التي يفرزها البنكراس. حتى جاء العالم 1921م ، عندما أعلن الطبيب الكندي الجراح فريدريك بانتنج (30 سنة) ، وزميله الكيميائي تشارلز بيست (22 سنة) من جامعة تورنتو ، عن نجاحهما في إنتاج مادة نقية من البنكرياس ، أطلقا عليا اسم أنسولين هذه المادة استطاعت عند حقنها في أجسام البشر أن تخفض كمية السكر. وبعد هذا الاكتشاف الباهر بسنتين في العام 1923م، حصل بانتينج الكندي، والبروفيسور ماكلويد البريطاني على جائزة نوبل العالمية في الطب بسبب اكتشافهما لمادة الأنسولين (شارك بانتينج زميله الكيميائي بيست ماديا في قيمة الجائزة). وكان هذا الاكتشاف العظيم ضمن اهم الاكتشافات في تاريخ العلوم الطبية على الإطلاق. فبعدها كان مرضى داء السكر من الرجال والنساء قبل اكتشاف هرمون الأنسولين، يموتون بعد سنة أو اثنتين على أكثر تقدير بسبب الغيبوبة وفقدان الوعي، أصبحوا بعد اكتشاف هذه المادة الهرمونية يتمتعون بوافر الصحة والعافية بدرجة لا تختلف عن أقرانهم الأصحاء. ولقد واصل العلماء جهودهم لمعرفة المزيد عن تركيب غدة البنكرياس والمواد الكيميائية التي تفرزها. والآن اتضح لنا أن البنكرياس لا يفرز هرمون الأنسولين فحسب، بل يفرز أيضاً هرموناً عظيم الشأن يعرف سام الجلوكاجون علاوة على طائفة من الأنزيمات الهاضمة. وكلا الهرمونين، الأنسولين والجلوكاجون، يعملان بطريقة مضادة. فالأول يخفض من مستوى السكر في الدم بينما الثاني يشجع على رفع مستواه بطريقة في غاية الدقة والإبداع تماما مثلما نحتاج إلى وسيلتين متضادتين من اجل زيادة سرعة السيارة وإيقافها حسب رغباتنا وتبعا لظروف الطريق.
وقد تبين لنا أن غدداً متخصصة تعرف باسم الغدد لصماء هي التي تقوم بإفراز الهرمونات. والغدد كما هو معروف واحدة من ثلاثة أنواع مختلفة من الغدد في الجسم هي:
الغدد القنوية:
كالغدد اللعابية مثلاً التي تصب إفرازها (اللعاب) عبر قنوات داخل تجويف الفم، والغدد الدمعية وغدد الحليب والعرق.
الغدد الصماء:
وهي التي ليس لها قنوات تصب فيها إفرازاتها، ولكن تصبها في الدم مباشرة لإحداث أثرها الفسيولوجي في مكان بعيد عن مكان إنتاجها . كالغدة النخامية في قاعدة الدماغ، والغدة الدرقية في الرقبة، والغدة الكظرية فوق الكلى.
الغدد المختلطة:
وهي التي تفرز نوعين من الإفرازات، أحدهما يصب في القنوات، والثاني يصب في مجرى الدم مباشرة. ومن أمثلة هذه الغدد المختلطة البنكرياس والغدد التناسلية (الخصية في الذكر، والمبيض في الأنثى).
والهرمونات لها وظائف عديدة ومهمة في الجسم، وبالإمكان معرفة وظائفها المختلفة بالطرق التالية:
- ملاحظة ما يترتب على إزاحة الغدة المعينة من الحيوان اليافع أو البالغ.
- زرع الغدة أو جزء من الغدة في حيوانات مختلفة الأعمار وملاحظة التأثيرات المختلفة التي تعقب ذلك الزرع.
- ملاحظة الأعراض المرضية الناتجة من تلف غدة معينة.
- حقن الهرمون في الحيوان بتركيزات مختلفة وملاحظة ما ينتجه ذلك من تأثير.
- الاستعاضة عن غدة مريضة بمستخلص غدة سليمة من نفس النوع وملاحظة النتائج.
وباتباع هذه الطرق المختلفة، وجد أن الهرمونات الحيوانية موجودة في كل من الفقاريات واللافقاريات.
المرجع:
مقدمة علم الحياة
الجزء الثاني ( التنظيم والتوجيه)، للدكتور أبو خطوة، الأستاذ المشارك بقسم علوم الأحياء ، كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.