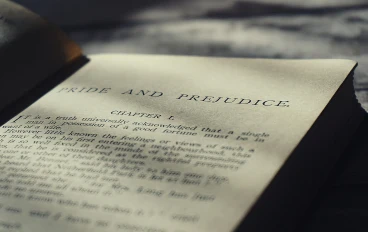رواية (منحنى قدري)... الفصل الثاني
"تنويه لابُدَّ مِنه"
إذا حدَث ووقعتْ هذه الرواية تحت يدِ أية فتاة أو امرأة، ووجدتْ تشابهًا فيما بينها وبين إحدى شخصياتها؛ فهو ليس من قبيل الصدفة إطلاقًا. لكنه القدر الذي قادها لتَسقطَ تحت وطأة الأحداث والسرد، وقادني لأدوِّنَ هذا السرد هنا، دونَ أية إرادة منِّي.
،،سالم أحمد سليمان،،
الثلاثاء 4/9/2018
(الثانية صباحًا)
عزيزي الذي بدأ يُطالع ويقرأ الآن أول كلمات هذا المخطوط؛ الذي سيضم ما بين أوراقه فيما هو قادم هذه الرواية. ستجد أنه منذ بدايته كما ترى؛ مخطوط بالحبر الأحمر. ومما لا شك فيه عندي أن القدر هو الذي ربط بين لون الحبر -الذي أراه من وجهة نظري مُعبِّرًا بشكل دقيق- ومضمون ما سيلي من سرد للأحداث في هذه الرواية؛ والتي ترددتُ كثيرًا قبل أن أبدأ في كتابتها الآن؛ ليس خجلاً مما سأرويه فيها كما يمكن أن تعتقد يا عزيزي، ولكن ربما هو التردد الناتج عن الخوف من الإقدام على عمل -كعادة الناس جميعًا- من شأنه أن يكون سببًا في دنو الأجل ووقوع الموت؛ ذلك لأن فكرة قاسية وهاجسًا مخيفًا سيطر عليَّ؛ وهو أنني بروايتي القادمة وتدويني لهذه الأحداث ستنتهي معها حياتي حالما أنهيها، فالأفكار التي دارت برأسي منذ بداية صباح أمس، ومنعتني النوم حتى الآن، وطاردتني في إصرار مثابر بتفانٍ رهيب ومستمر، وبشكل مُلحٍّ غريب؛ ملأتْ عليَّ كل تفكيري، ومنعتني وأثنتني عن الخروج من منزلي، أو مجرد حتى النظر للشارع من النافذة، أو مزاولة أي نشاط معتاد، وترددتُ كثيرًا قبل الاستسلام لها، بعد أن اجتهدت محاولاً التملص والهروب منها ومن كتابتها، وطردها تماما من رأسي، أو محاولة التغافل عنها؛ أحيانا بالتفكير في كتابة أي شيء آخر غيرها، أو بقراءة ما هو بعيد عن الروايات والأدب برمته، أو بمتابعة قنوات بعينها على التلفاز لا صلة لها سوى بكل ما هو سطحي وساذج، أو الانخراط في المتابعة المنتبهة للنشرات الإخبارية التي تنقل ما يدور في العالم من تقلبات سياسية، وحروب متفرقة، وكوارث قائمة أو مُتنبأ بها. لكن كانت كلها محاولات باءت بالفشل الذريع، فلم أستطع أن أبرأ بتفكيري بعيداً لأنجو منها، بل على العكس تمامًا، فكانت كلما حاولت طردها من رأسي ونفيها عنه؛ ازدادت استيطانًا واحتلالاً له، حيث تمثلت لي تلك الأحداث التي دارت برأسي في كل شيء مهما كان صغيرًا وبسيطًا، أو اعتياديًّا غير ذي قيمة؛ لدرجة أن حتى فنجان القهوة كان منذ البدء في تناوله يتحول وجه البن فيه ومع كل رشفة إلى ما يشبه شاشة صغيرة؛ تعرض عليَّ ذكريات أحداث متفرقة مما مضى من عمري؛ كأنها (برومو) سريع لما سوف تكون عليه روايتي، واستعدتُ في رأسي تفاصيل كثيرة متباينة في أزمنتها من حياتي السابقة؛ ظننتها غابت عني في مجاهل الذاكرة البعيدة والمظلمة، وعندما ربطت في تدقيق عميق دلالات هذه الأحداث وتنامي وقائعها متنبئًا بما ستؤول إليه من نتيجة لابد منها؛ وجدتها تسير في شكل يشبه منحنى العمر تمامًا؛ حين يبدأ الواحد منا حياته رضيعًا، ثم طفلاً، ثم يمر بالصبا، تاركًا إياه للشباب، بعدها الكبر، ثم الشيخوخة، قبل أن ينتهي بالموت. ذلك المنحنى الذي يتخذه عمر الإنسان من ميلاده حتى موته، إن لم يحدث ما يُخِلُّ بالترتيب والتدرج الطبيعي لنصف استدارته المعتادة، الذي مثلما بدأناه أطفالاً غير قادرين، يحتاجون لمن يرعاهم ويساعدهم في القيام بحاجاتهم الأساسية المتطلبة للحياة من المأكل والشراب والاغتسال وقضاء الحاجة والتنقل هنا وهناك، ننهيه شيوخًا عاجزين، يحتاجون أيضًا لمن يتولاهم ويقوم لهم بنفس المتطلبات. لكن الفرق بين طفولتنا القاصرة، وشيخوختنا العاجزة؛ أننا في الأولى نحتاج لمن هم أكبر منا لنبدأ حياتنا، وفي الثانية نحتاج لمن هم أصغر منا حتى ننتهي منها.
أما أنا الشاب الذي سيبلغ سنُّه الأربعين بعد أقل من عام، حيث تعتبر نقطة سن الأربعين على ذلك المنحنى العمري هي نقطة المنتصف القصوى لذلك المنحنى قبل أن يبدأ في الهبوط تدريجيًّا مرة أخرى نحو الموت، لماذا أشعر باقتراب وشيك للنهاية، رغم أنني ما زلت حتى الآن محتفظًا بقواي الجسدية التي تمكنني بسهولة من السير، والمأكل والمشرب، والتنقل من مكان لآخر، والعمل، وممارسة أنشطتي الحياتية كما أريد، ولا أحتاج لأحد في شيء تقريبًا، ولا شك في أنني ما زلت أقوم بقضاء حاجتي بنفسي متواريًا بعضوي ومؤخرتي عن الأنظار، وأستطيع صعود الدرجات الخمس وستين المؤدية لشقتي بالدور الأخير من المبنى ذي الأربعة طوابق دون أن تتقطع أنفاسي، ومن غير أن أتوقف لالتقاطها بين طابق وآخر، حتى لو صعدت وهبطت تلك الدرجات لأكثر من ثلاث أو أربع مرات يوميًا، وربما كان الزمن الذي يفصل بين هبوطي وصعودي في إحدى المرات لا يتجاوز الدقيقتين، حين أكتشف أمام الباب المغلق للشقة التي أسكنها أنني نسيت كالعادة شيئًا ما؛ هاتفي المحمول مثلاً، أو المفاتيح، أو أي شيء آخر بسيارتي الحمراء الواقفة تحت هذا المبنى، كما أنني لازلت أملك أمر عقلي ولا تشوبه شائبة من خبال أو خرف، وسلوكي الكلي ما زال متزنًا وسليمًا لدرجة كبيرة وتامة على ما أظن حتى الآن.
بالفعل تمامًا؛ الأمر بالنسبة لي بعيد بشكل قاطع -لا شك عندي فيه- عن تدني القوى الصحية والعقلية التي تصاحب التقدم في السن، أو شيخوختنا القاسية والمخجلة؛ إنه يتعلق بأمر آخر، أمر بعيد تمامًا عن كونه سلوكًا حيويًا، أو نشاطًا ذهنيًا؛ لكنه تفاعل اجتماعي عاطفي خالص؛ يتعلق بمسيرتي الغرامية في حياتي حتى هذه اللحظة؛ التي تتمثل لي؛ أي مسيرتي الغرامية؛ في أنها -بعد حوالي عشرين سنة وهي مدة خمس علاقات غرامية مضطربة- هي أهم أنشطتي الحياتية وأكثرها وأبلغها شِدَّة وتأثيرًا في نفسي، وفي مسيرة تقدمي في الحياة أيضًا؛ تلك العلاقات التي انتهت أخيرتها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر؛ وهي العلاقة التي لم تختلف تفاصيلها كثيرًا عن أول العلاقات التي عشتها من وقت شبه بعيد، عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري لمدة تزيد عن أربع سنوات كاملة مع أول فتاة شعرت نحوها بعاطفة عزيتها ورددتها للحب، تلك العلاقة العذرية التي لم تتعد المكالمات الهاتفية المختلسة، والخطابات الشاعرية المسربة سرًا، والأحلام المأمولة -رغم العلم باستحالتها- في زيارات لأماكن خالية إلا منا نحن الاثنين؛ كجزيرة منعزلة في البحر، أو الجلوس متقاربَين على شاطئ بعيد، أو قضاء ليلة على ضوء الشموع، أو سهرة رومانسية فوق رمال شاسعة تحت النجوم والقمر، وما إلى ذلك من تصورات سينمائية، وخيالات مُراهِقة حالمة وبريئة، وانفعالات عاطفية للحب الأول. كل ذلك دون ولو حتى مجرد التفكير بتاتًا بقُبلة ولو محتشمة، أو عناق خفيف؛ يؤديان إلى إيقاظ ما هو كامن من مشاعر جسدية وحسية بداخلنا. وقد تصاعد هذا المنحنى من تلك العلاقات الغرامية ليصل إلى ذروة العشق عند العلاقة الثالثة قبل أن ينحدر مرة أخرى في الرابعة، ويعود هابطًا في الأخيرة إلى العذرية كما بدأ. وهكذا هو منحنى قدري.
ربما اتضحت الآن لك يا عزيزي تلك العلاقة بين اللون الأحمر والأحداث التي سأرويها؛ فكلمة الغراميات أكثر ما يليق بها هو اللون الأحمر أو أنه غالبًا -من منظور، وفي رأي الكثيرين- اللون الأوحد المرتبط في العقل الباطن بمدلول الحب، أو العشق وممارسته. بينما القدر الذي ربط بين اللون الأحمر و كتابة مخطوط هذه الرواية؛ تمثل لي في أنه عندما واتتني الشجاعة، أو بتعبير أصدق؛ الاستسلام لعصف أفكاري المتزايد واللحوح لأبدأ الكتابة الآن، أو بالأدق ساقني القدر لذلك؛ بحثت في أرجاء الغرفة من حولي؛ في الأدراج وعلى المنضدة، وبين رفوف المكتبة الصغيرة التي احتلت نصف حائط من إحدى حجرات منزلي برفوفها الخمسة؛ لم أجد على كل تلك الرفوف، أو في هذه الأدراج، أو بين كل الكتب؛ سوى قلم أحمر بدون غطاء مُلقى بإهمال فوق أحد الكتب بالرف الثاني المتراصة عليه بعناية وترتيب دقيق عدد من عشرات الروايات، التي حافَظَتْ على ترتيبها وتناسقها بهذا الشكل لأنني كنت قد أتممت قراءتها جميعها وبلا استثناء، من فترة قريبة، وقد تبدو حتى الآن أنها مصادفة ليس أكثر وجود هذا القلم الأحمر الوحيد في هذا المكان، ولكن كيف لهذه المصادفة إضافة إلى تلك الظروف والهواجس المقلقة، وزخم الذكريات وبعثها واضحة من موتها بالنسبة لي، وتتابع ترتيب الأحداث التي تمثلت بسردها المستقبلي -في رأسي- عما ستكون عليه هذه الرواية؛ أن تتسلسل بكل هذه الدقة هكذا:
أولاً: فكرة كتابة رواية عن غراميات تترتب الواحدة منها تلو الأخرى في ذلك المنحنى الزمني، الذي يؤول في النهاية إلى الصفر مثلما بدأ، وذلك التوقيت تحديدًا الذي زاد فيه إلحاح تلك الفكرة وطرقاتها المتتابعة على رأسي والتي أجبرتني أن أشرع منقادًا، ومعدوم القدرة على التمسك بالرفض؛ لتسجيلها رغم خوفي وترددي في البداية من ذلك.
ثانيًا: القلم الوحيد الذي وجدته بين كل ما هو حولي هنا وأخط به ما تقرأه الآن يا عزيزي هو قلم ذو لون أحمر وحبر أحمر؛ اللون المرتبط عادة في المخيلة الإنسانية بالحب والإثارة في نفوسنا.
ثالثًا: وهو الأمر الذي لا يترك أي مجال للصدفة على الإطلاق؛ أنه دونا عن كل مئات الكتب المتراصة على الرفوف استقر هذا القلم بدون غطائه فوق رواية (ذاكرة غانياتي الحزينات) للكاتب الكولومبي الأشهر (ماركيز)؛ التي إحدى محصلاتها الرئيسية المدونة على الغلاف الخارجي للرواية: "أن هناك بين احتمالات الموت؛ أن يموت المرء حبًّا، مهما كانت السن التي بلغها"، لتتمثل أمامي، حية وطازجة، قبل أن أبدأ الكتابة، ثنائية الحب والموت.
إذن من غير الممكن أن تكون هذه النقاط الثلاث اجتمعت هكذا فيما بينها وبتسلسلها ذلك من قبيل المصادفة، إنها بالتأكيد ليست سوى نداءات القدر؛ أوامره التي نلبيها، منصاعين لها رُغمًا عنا، حتى لو ظننا أنها مصادفات قد ارتمت في الطريق تحت أقدامنا؛ ففي الحياة لا مجال لذلك أبدًا؛ فالصدفة هي كلمة كانت ولا تزال دائمًا مواربة، وباعثة أحيانًا -بفتنة مُحبَّبة خادعة- على الشعور بالطمأنينة إلى حد ما، ومسوغة للاعتماد الكلي الزائف والإرتكان لانتفاء السببية عن ما يحدث لنا. كلمة أدخلناها ونستخدمها في قاموسنا الحياتي بكثرة ربما كوسيلة أو حيلة من الحيل الدفاعية النفسية السهلة، فقط لتبرير إخفاقاتنا أو سقوطنا مرغمين في يد ذلك القدر، وانعدام قدرتنا على الفكاك من قبضته المسيطرة، أو الهروب من براثنه وفخاخه المُحكمة، التي دائما ما نقع في شراكها مهما حاولنا الإفلات منها، وإننا لو طالعنا جيدًا وتأملنا محاولات معظم الفلاسفة في بحثهم عن الحقيقة في فلسفاتهم سواء الميتافيزيقية منها أو الطبيعية؛ لوجدناها كلها تؤول في النهاية إلى نتيجة مفادها أن الكون بدأ صيرورته الأولى، ثم ليسير بعدها ويتقدم وينمو، قبل الجنوح نحو الفناء والعدم كما انبعث منه، وكذلك الإنسان في ترتيب أحداث حياته منساق تحت وطأة قوى فوقية عُليا؛ هي التي تصوغ له مقدراته وتنظم خطواته التي يخطوها بالتتابع والترتيب المفروض عليه سلفًا من هذه القوى؛ إلهية كانت أو غير ذلك، والتي تُسيِّره في النهاية في كل أحواله نحو الموت؛ الذي هو الحقيقة الوحيدة المطلقة التي لا ينكرها أحد مهما كانت معتقداته. وحتى لا نبتعد كثيرًا، فإن الأحداث التي ستلي من روايتي اختارت وقتها، ولون كتابة مخطوطها، وموضوعها؛ دون إرادتي الشخصية، لكنه -بالتأكيد- قدري الذي لا أعرف حتى الآن أو فيما بعد هل سيمنحني الوقت لإتمامها، أم أن النهاية الحتمية المتمثلة في موتي -التي لن تُرى على الورق بالتأكيد- لن تمهلني لأتم ما شرعت فيه من سرد لتلك العلاقات المتتالية في منحنى غرامياتي، فأنا الراوي الذي لابد أن ينهي الأحداث حيًّا، فبدوني لن تكتمل الرواية.
…….انتهى الفصل الثاني…
إسلام سلام