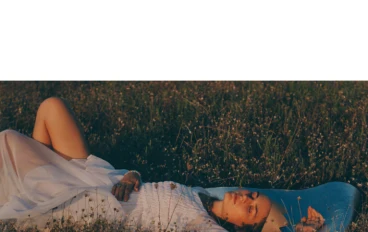حين يزهر الحب بين صفحات الكتب"
في أحد الأحياء القديمة من مدينةٍ تغفو على ضفاف النيل، حيث تمتزج رائحة الخبز الساخن بأصوات الباعة وأجراس الكنائس القريبة، كانت “ليلى” تمشي كل صباح إلى محل صغير للكتب المستعملة ورثه والدها منذ عقود. لم تكن تتجاوز الخامسة والعشرين، وعلى كتفيها استقرت أحلام كثيرة، وبين صفحات الكتب التي تبيعها خبّأت قلبًا دافئًا وروحًا مشبعة بالحكايات. اعتادت أن تقول إن الكتب أوفى من البشر، لأنها لم تُخذَل يومًا من رواية، فيما خانتها قلوب كثير من المحيطين.
في أحد صباحات أكتوبر التي تميل فيها الشمس لتكون أكثر حنانًا، وقف أمام المكتبة شاب لم تره من قبل. وسيم بطريقة لا تخطف العين بقدر ما تؤنس القلب؛ يرتدي قميصًا أبيض وسترة رمادية بسيطة تحمل أناقة غير متكلفة. اقترب بخطوات هادئة، ومد يده لها بابتسامة لطيفة قائلًا:
"صباح الخير، هل أجد عندكِ رواية رائحة الزمن؟"
تأملته قليلًا، ثم أجابته بابتسامة صغيرة:
"أجل، لدينا نسخة نادرة، هل تحب القراءة؟"
ضحك الشاب بخجل: "أنا كاتب، وأبحث عن الإلهام."
رفعت حاجبيها بدهشة: "آه... هذا يفسر اهتمامك بالكتب القديمة."
أجاب: "أبحث عن حكاية مختلفة هذه المرة، وربما أجدها هنا."
كان اسمه “يوسف”، كاتب شاب يحمل في قلبه شغفًا عظيمًا بالكلمات. لم يكن غريبًا أن يقع في حب المكان قبل أن يقع في حب صاحبته. بدأ يتردد على المكتبة يومًا بعد يوم، يشتري كتابًا، ثم يجلس على الكرسي الخشبي أمام المكتبة يتحدث مع ليلى في كل شيء... عن الحياة، عن أحلامه، وعن معنى أن يجد المرء شخصًا يفهمه دون أن يتكلم كثيرًا.
كانت ليلى في البداية تظنه مجرد زبون عابر، لكنها ما لبثت أن اكتشفت أن قلبها بدأ يسابقها كل صباح كي يسبق خطواته، ويجلس بشغف ينتظر زيارته اليومية. أصبحت تصنع له القهوة بنفسها وتجهز له ركنًا خاصًا يقرأ فيه. صار وجوده جزءًا من تفاصيل يومها، بل صار هو تفاصيل اليوم كله.
في إحدى الأمسيات الماطرة، حلّ يوسف متأخرًا عن موعده المعتاد. بدا عليها القلق بشكل لم تتمكن من إخفائه، ولسان حالها يسأل نفسها إن كان سيأتي أم أن تلك الزيارات كانت مجرد صدفة سينتهي أثرها قريبًا. لكن يوسف جاء يحمل بين يديه وردة بيضاء وكتابًا قديمًا مرفوع الغلاف بلا عنوان. سلّم عليها وهو يبتسم بامتنان، ثم قال:
"هذا الكتاب لا يقرأه إلا من يستحق أن يعيش قصة حب حقيقية."
نظرت إليه بدهشة، وابتسمت بتورد: "وهل تظن أنّي أستحق ذلك؟"
أجابها بثقة ناعمة:
"بل أنا متأكد أنكِ تستحقين أكثر مما تحمله الكتب من حكايات."
ترددت الكلمات في صدرها، ولم تستطع سوى أن تقول:
"شكرًا يا يوسف... لم يسبق أن قال لي أحد هذا الكلام."
مرّت الأيام، وبدأت تفاصيل العلاقة تنسج خيوطًا عميقة بين قلبيهما. لم يعد يوسف يكتفي بالمجيء إلى المكتبة، بل صار يصحبها إلى أماكنها المفضلة، إلى مقهى قديم على النيل حيث يشربان الشاي بالنعناع ويتبادلان الحديث عن المستقبل. عرفت ليلى للمرة الأولى معنى أن يكون لها شخص تسمح له أن يراها حين تكون ضعيفة. صار يوسف بمثابة المرفأ الذي تسند عليه قلبها، بعد أن سئمت العبث في محطات لا تصل إلى شيء.
لكن كما في كل الحكايات، لا بد للقدر أن يختبر صدق الحب.
في بداية الشتاء، أتى يوسف إلى المكتبة وعلى وجهه شيء من الحزن، وعيناه تتهربان من عينيها. لاحظت الأمر وسألته بقلق:
"ما بك؟ هل حدث شيء؟"
تنهد طويلًا ثم قال:
"عُرضت عليَّ فرصة للعمل في مدريد ككاتب مساعد في دار نشر كبيرة، لكن ذلك يعني أن أغادر خلال أسبوع... وأظل هناك سنة كاملة."
ساد الصمت داخل المكتبة. بدت الكتب وكأنها توقفت عن الكلام، والهواء نفسه أصبح أثقل من أن يُتنفَّس.
قالت بصوت مكسور: "سنة؟!"
أجاب: "أجل… وأنا لا أريد أن أتركك، لكني أيضًا لا أريد أن أضيع هذه الفرصة."
بابتسامة حزينة حاولت أن تكون قوية أمامه، قالت: "اذهب يا يوسف، فالحياة لا تمنحنا الفرص كثيرًا. وإن كان لنا نصيب، فسنلتقي."
نظر إليها وكأن قلبه يُنتزع من صدره، ثم قال:
"سأعود… وإن عدت سأطلب يدك."
سافر يوسف، تاركًا خلفه وعدًا وحقيبة من الأشواق لا تنتهي. أرسل لها رسائل طويلة يكتب فيها كل التفاصيل، كيف يفكر فيها كلما أمسك قلمًا وبدأ يكتب، وكيف يختم يومه بصورة المكتبة التي التقطها ذات صباح وهي تبتسم أمام بابها الخشبي. كانت ليلى تقوى برسائله، وترفض أن تسمح للحزن أن يتسرب من قلبها. وفي إحدى رسائله كتب لها:
"لقد بدأت كتابة رواية... أبطالهما يشبهاننا كثيرًا، أريد أن أنشرها عندما أعود، وأضع في الإهداء: (إلى من جعلت قلبي يعرف الحب)."
مرّت السنة كأنها مئة عام، وكل صباح تنتظره بلهفة، وترتب كتابًا جديدًا في مكانه، وتضع قهوته على الطاولة، حتى أصبحت كتب المكتبة تحفظ سيرة هذا الحب الصامت. وفي يوم ربيعي دافئ، بينما كانت منهمكة في ترتيب رف الروايات، سمعت صوت خطوات مألوفة خلفها وصوتًا يهمس:
"هل ما زال الكرسي الذي أجلس عليه شاغرًا؟"
استدارت بقوة، فلم ترَ سوى يوسف يقف أمامها بملامحه التي زادها الشوق وسامة وحنين. سقطت الكتب من يدها، وامتلأت عيناها بالدموع. لم تستطع الكلام، فاقترب منها ووضع يده على قلبه قائلًا:
"أوفيت بوعدي… عدتُ لأطلب يدك."
انفجرت بالبكاء، وهي تضحك في ذات الوقت، قبل أن تقول بصوت مخنوق:
"وكأنك تأخرت عمرًا كاملًا…"
لم يحتج الأمر سوى أيام قليلة، حتى اجتمع الأحبة داخل المكتبة العتيقة التي تحوّل ركنها إلى مسرح صغير لحفل خطوبتهما. زيّن يوسف المكان بالورود، وكتب على السبورة التي تتوسط الحائط الخلفي:
"هنا تبدأ كل الحكايات الجميلة."
خطبا وسط فرحة الأصدقاء والجيران، وبدأت ليلى تحلم ليس فقط بحياة جديدة معه، بل بمكتبة أكبر تجعل منها دار نشر صغيرة لكتابات يوسف. وبالفعل، بعد أشهر من الزواج، افتتحا معًا دارًا للنشر بجانب المكتبة، وأطلقا عليها اسم "نبض"، ليكون رمزًا لهذا الحب الذي بدأ بنبضات الكلام على صفحات الكتب.
صار يوسف كاتبًا مشهورًا، تنشر رواياته في أنحاء العالم، وترافقه ليلى في كل حفلات توقيع كتبه، تُمسك يده بفخر، وتهمس في أذنه دائمًا:
"لو عاد بي الزمن ألف مرة... سأختارك بنفس الدهشة."
ويرد عليها:
"أنتِ قصتي الأجمل، التي لا تنتهي."
---
وهكذا، ظلت الحكاية التي بدأت بين رائحة الكتب القديمة وكوب القهوة، تكبر يومًا بعد يوم، وتعلّم كل من حولها أن الحب ليس ضربة قدر عابرة، بل هو "قرار" أن نبقى، وأن نؤمن، وأن ننتظر، وأن نحلم معًا... وأن نسقي قلوبنا بالوفاء حتى تنبت فيها الورود، حين يجيء الحب 💗