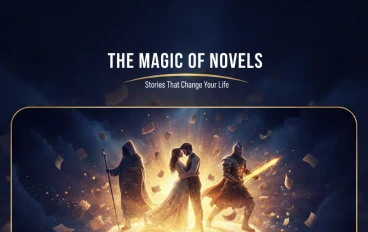بيوت على شاطئ الذاكره
بيوت على شاطئ الذاكره
الفصل الرابع – رسائل البحر الخفيّة
كان الصباح التالي مختلفًا قليلًا؛ رائحة البحر بدت أثقل من المعتاد، كأن الموج أرسل مع نسيمه همسًا لا يفهمه إلا من عاش قربه سنوات طويلة.
استيقظ خليل أوّلًا، وخرج إلى الشرفة يراقب الشاطئ البعيد. رأى البحارة يسحبون قواربهم بصمتٍ غير مألوف، ورجالًا يتجمعون قرب الميناء وهم يتحدثون بوجوه متجهمة.
في الفناء، كانت أم خليل تعجن العجين، بينما الجد يلمّ مسبحته ويحدّق في الأفق، كأنه يبحث في الموج عن خبرٍ ضاع بين الأمواج.
سألته ليلى وهي تستعد للمدرسة:
"جدي… لماذا يبدو الناس قلقين اليوم؟"
ربت الجد على رأسها بحنان وقال:
"البحر يا ليلى مثل القلب… حين يختلّ نبضه، يشعر كل من يحبه بالاضطراب. لكن لا تخافي، لكل موجة سبب، ولكل هدوء حكمة."
في طريقهم إلى المدرسة، كان يوسف يلتفت من حين لآخر نحو الميناء.
رأى رجالًا غرباء لا يعرفهم، يرتدون ملابس ليست مألوفة في تل الربيع.
تبادل النظرات مع أحد التجار، فهمّس له التاجر بصوت منخفض:
"هناك سفن جديدة وصلت الليلة… ليست سفن تجارة يا يوسف."
لم يجب يوسف، لكنه شدّ على يدَي طفليه أكثر.
في المدرسة، حاول الأطفال متابعة يومهم الدراسي كالمعتاد.
لكن المعلم نفسه — الرجل الذي قال لهم بالأمس إن الحروف وطن — كان يكتب على اللوح ببطء، ووجهه يحمل ظلّ قلق لم يستطع إخفاءه.
خارج النوافذ، بدا البحر مضطربًا.
كانت ليلى تنظر إليه وتشعر بأن المياه تريد أن تقول شيئًا… شيئًا كبيرًا، أقوى من طاقتها على الفهم.
عند عودتهم إلى البيت، جلسوا جميعًا في الفناء.
قال يوسف لوالده:
"الأخبار تتكاثر… والغرباء يزدادون. لكننا سنبقى هنا، مهما حدث."
هزّ الجد رأسه وقال:
"البيوت تُحمى بالقلوب قبل الجدران. لنبقى متيقظين، ولندع الأيام تكشف نواياها."
ورغم القلق الذي تسلل إلى زوايا النهار، كانت رائحة البرتقال ما تزال تعبّئ الهواء، تؤكد لهم أن الحياة — مهما اضطرب البحر — ما تزال تنبض في يافا.
الفصل الخامس – ليلةٌ تحت ضوء الفوانيس
مع غروب الشمس، اشتعلت الفوانيس المعلقة على جدران البيوت، وبدأت تلّ الربيع يتلألأ بأضواء خافتة تشبه النجوم الأرضية.
أرادت أم خليل أن تعيد للبيت بعض الدفء، فقالت:
"سنصنع كعكًا بالسمسم الليلة. الأطفال يحبونه… والفرح لا ينتظر الظروف."
انتشرت رائحة الكعك في البيت، فاجتمعت ليلى وخليل قرب المطبخ يراقبان أمهما وهي تشكّل الأقراص برشاقة.
ضحكت ليلى:
"سأعطي معلّمي قطعة غدًا. قال إنّ الحروف بذور… سأعطيه قطعة تذكّره ببيوتنا."
جلس الجد في الفناء، وعلى ضوء الفانوس أخذ يحكي قصة قديمة عن صياد من يافا تحدّى العاصفة ليصل بالسفينة إلى شاطئ المدينة.
كان الأطفال يستمعون إليه بشغف، خليل يرفع حاجبيه كلما اشتدّ وصف العاصفة، وليلى تضمّ ركبتيها بإثارة.
لكن وسط الحكاية، سمع الجميع أصواتًا من بعيد — خطوات كثيرة، غير مألوفة.
تبادل يوسف وأبوه النظرات، ثم نهض الأب وقال بهدوء:
"ابقوا هنا… سأخرج لأرى."
عاد بعد دقائق، جالسًا إلى جانبهم وهو يحاول أن يبدو مطمئنًا:
"مجموعة من الغرباء تمر نحو الميناء… لا أكثر."
لكن يوسف لم يستطع إخفاء قلقه.
ظلّ ينظر نحو الباب كل حين، كأنه يتوقع شيئًا لم يصل بعد.
اقتربت ليلى من أبيها وهمست:
"أبي… هل سيبقى بيتنا كما هو؟"
ضمّها يوسف إلى صدره، وقال بصوت يحمل من الصدق بقدر ما يحمل من الخوف:
"طالما نحن هنا، سيبقى البيت… والبرتقال… والبحر."
وبينما ارتفعت رائحة الكعك من جديد وعمّ الدفء الفناء، ظلّت الهمسات القادمة من الأزقة تتداخل مع أصوات الموج، كأن المدينة نفسها تقف بين يومين — يوم مضى مليئًا بالطمأنينة، ويوم قادم لا يعرف أحد شكله.
لكن تلك الليلة، على الأقل، ظلت يافا مضاءة بالفوانيس… وبالقلوب التي ترفض أن تُطفئها الرياح.
وسأكمل البناء معك.
الفصل السادس – الموج الذي تغيّر لونه
مع نهاية أسبوعٍ ثقيل، بدا أنّ المدينة لم تعد كما كانت.
الناس يمشون بسرعة، والوجوه قلقة، والباعة في السوق ينهون عملهم مبكرًا.
ظلّ يوسف يحاول أن يحمي عائلته من الأخبار التي تتناقلها الألسن، لكن الحقيقة كانت تصل إلى مسامع الجميع عبر الموج، عبر نظرات الرجال، وعبر صمت الطرقات.
في هذا الصباح، اقترب جارهم أبو حسن من يوسف وقال له بصوت مرتجف:
"سفن جديدة رست في الميناء الليلة… السفن التي كنا نخاف وصولها."
تجمد يوسف في مكانه، بينما أحسّ خليل بشيء يشبه الحجر يسقط في معدته.
لم يجرؤ على السؤال، لكن ليلى، بعفويتها، قالت:
"أبي… هل جاء ناس يريدون بيوتنا؟"
أجاب يوسف بعد صمتٍ طويل:
"مهما جاء، سنبقى واقفين… مثل شجرتنا."
مع حلول المساء، رأوا من بعيد دخانًا خفيفًا يرتفع قرب الميناء.
لم يعرفوا ماذا يعني ذلك.
لكن الجد هزّ رأسه وقال:
"حين يتغير لون البحر… اعرفوا أن مدينتنا على وشك الامتحان."
–––––––––––––––––––
الفصل السابع – ليلة الطرق على الأبواب
مرت الساعات ثقيلة، حتى جاء الليل حاملاً معه خبرًا لم يتوقعه أحد.
معظم الرجال في الحي تجمّعوا قرب الأزقة، ينظرون إلى آخر الطريق حيث كان الجنود الغرباء يقتربون خطوة بعد خطوة.
في بيت آل الكرمي، جلست ليلى تحتضن دفتر المدرسة، وخليل يقف قرب الباب كأنه يحرس العالم كله.
يوسف كان يذرع الغرفة ذهابًا وإيابًا، والعرق يتصبب من جبينه رغم برودة الليل.
فجأة… دوّى طرقٌ عنيف على أحد أبواب الحي.
ثم آخر… وثالث.
اقتربت الخطوات.
تقدّم الجد، رغم سنه، وأغلق الباب الخشبي بإحكام.
همست أم خليل:
"ماذا يريدون؟"
ردّ يوسف بمرارة:
"يريدون أن نصمت… أن نترك… أن نختفي."
لكن صوتًا من الخارج صاح:
"اخرجوا! هذا الحي تحت السيطرة!"
ارتجفت ليلى، لكن الجد أشار إليها:
"لا تخافي… الصوت العالي لا يعني أنه الأقوى."
لم يقتحم أحد البيت، لكن الأصوات حولهم كانت كافية لتجعل تلك الليلة أطول ليلٍ مرّ على العائلة.
حين هدأ كل شيء فجأة…
كان الهدوء مخيفًا أكثر من الضجيج.
–––––––––––––––––––
الفصل الثامن – الطريق التي لا تشبه الطرقات
مع الفجر، لم يكن أمام يوسف سوى قرار واحد.
لم يعد البقاء في البيت آمنًا، لكن الرحيل عنه كان كخلع جزء من الروح.
جمعوا ما استطاعوا حمله:
قطعة كعك من الليلة الماضية، صرة صغيرة، صورة واحدة للبيت، ودفتر ليلى الذي يحمل كلمة “يافا” بخط المعلم.
عندما خرجوا إلى الأزقّة، كانت البيوت تُفتح واحدًا تلو الآخر، والناس يخرجون مثله… لا يعرفون إلى أين يذهبون، لكن يعرفون أنهم مضطرون للمغادرة.
سارت العائلة مع الجموع.
ليلى تمسك بيد أمها، وخليل يمسك بيد أبيه، والجد يسير بخطوات ثابتة رغم سنه.
عند نهاية الحي، التفت يوسف إلى البيت للمرة الأخيرة.
شجرة البرتقال كانت واقفة، أغصانها تتحرك كأنها تلوّح لهم… أو تبكي معهم.
قال يوسف بنبرة محطمة:
"بيتنا… سيبقى هنا. البحر يعرفه… والسماء."
لكنّ الجد وضع يده على كتفه وقال:
"البيت ليس حجارة يا بني… البيت هو مَن يمشي الآن أمامي."
تابعوا السير…
وفي الطريق، دوّى صوت انفجار خافت من جهة الميناء.
ارتعشت خطوات ليلى.
قالت بصوت منخفض:
"البحر… ماذا حدث للبحر؟"
لم يجب أحد.
–––––––––––––––––––
الخاتمة – حين يمشي الوطن على قدمي طفل
لم يكن الطريق الذي خرجت إليه عائلة آل الكرمي يشبه أي طريق عرفوه من قبل.
لم يكن يشبه أزقة تل الربيع الضيقة المبللة برائحة القهوة، ولا الأسواق العامرة، ولا الساحات التي كان صوت الباعة يملؤها.
كان طريقًا بلا ملامح… كأنه بدأ فجأة من قلب المدينة وامتدّ نحو المجهول.
كانت الشمس ترتفع ببطء، تلتهم ظلال البيوت خلفهم.
وفي كل دقيقة تمضي، كانت تلك البيوت تفقد لونًا آخر، وملمسًا آخر، وتنساب من ذاكرتهم كما تبتعد سفينة عن اليابسة.
جلسوا تحت شجرة زيتون عظيمة على مشارف يافا.
كانت جذورها تمسك بالأرض بقوة، كأنها ترفض أن تتركها مهما حدث — مشهد جعل قلب يوسف ينكسر مرة أخرى.
تنفّس الجد بعمق، وكأنه يبتلع حزنه حتى لا يراه الأحفاد.
ثم قال بصوت متهدّج لكنه ثابت:
"أتعلمون يا أولادي؟
حين يترك الإنسان بيته، لا يترك جدرانًا… يترك عمرًا كاملًا.
وما أثقل أن نحمل أعمارنا على أكتافنا ونمضي."
كانت ليلى جالسة قرب أمها، وقد ألصقت الدفتر بصدرها، كأنه آخر ما يربطها بالمدرسة والبحر والنافذة الزرقاء.
أما خليل فكان ينظر إلى يديه، يشعر أنه كبر سنوات وليس أيامًا.
سألته ليلى بصوت مرتجف:
"خليل… هل تعتقد أن أحدًا يسكن بيتنا الآن؟"
ردّ قبل أن يفكر:
"مهما دخلوا… لن يعرفوا رائحة البرتقال كما نعرفها."
التفت يوسف إلى الأبناء، نظر إلى عيونهم الصغيرة التي تحاول أن تفهم ما لا يفهمه الكبار أنفسهم.
كان يريد أن يقول شيئًا يخفّف الألم… لكنه لم يجد ما يقوله.
فمدّ يده نحو الأرض، قبض على حفنة تراب، وتركها تنساب من بين أصابعه.
همست أم خليل وهي تنظر إلى الطريق الطويل:
"يافا خلفنا… لكن قلبي ما زال فيها."
اقترب الجد من يوسف، ووضع يده على كتفه كما فعل في طفولته، حين كان الصغير يبكي خوفًا من موجٍ مرتفع.
قال له بنبرة الأب الأخير:
"اسمع يا يوسف…
سنرحل بأجسادنا، لكننا سنبقى هناك بقلوبنا.
البيوت التي تُهدم تُبنى من جديد…
لكن البيت الذي يُهدم في القلب، لا يبنيه أحد إلا الذاكرة."
سقطت دمعة من عين ليلى، وأخرى من عين أمها.
أما خليل، فلم يبكِ — لم يعد للبكاء مكان في صدر طفل صار فجأة أكبر من عمره.
وقف الجد بصعوبة، نظر نحو يافا البعيدة.
كانت المدينة تبدو كأنها تختفي خلف غبار الطريق… أو ربما خلف دموع من يرحلون عنها.
رفع رأسه وقال بصوت قوي رغم ارتجافه:
"سنعود… وإن لم نعد نحن، سيعود أولادنا…
سيعود اسمنا… ستعود خطواتنا…
لن تبقى يافا بلا أهلها، مهما طال الطريق."
هبت نسمة من جهة البحر، نسمة رطبة تحمل شيئًا من رائحة البرتقال، شيئًا من صوت الموج، شيئًا من ضحكات الأطفال التي تركوها خلفهم.
كانت كأنها تحاول أن تلحق بهم… ألا تسمح لهم بالابتعاد.
أغمضت ليلى عينيها… رأت الشجرة في الفناء، النافورة الصغيرة، رأت المدرسة والعلم الفلسطيني يرفرف، رأت دفّ أبي رامز في ليلة الفوانيس، رأت كل شيء…
ثم قالت بصوت خافت لكنه ممتلئ بحقيقة أكبر من سنها:
"يافا لن تغادرني… حتى لو غادرتها."
ابتسم الجد، دمعة تتعلق في رمش عينه وهو يتمتم:
"هكذا تبدأ البيوت الحقيقية يا حفيدتي…
لا على الأرض، بل على شاطئ الذاكرة."
ثم تابعوا السير.
وكأن كل خطوة كانت تبني جدارًا جديدًا في قلب الزمن.
وحين اختفت يافا وراء الانحناءة الأخيرة من الطريق…
لم تختفِ منهم — بل أصبحت خالدة، محمولة على أكتاف الرحيل، تسكن الحقائب، والعيون، والقلوب.
وهكذا انتهت الحكاية…
وبقيت البيوت — وإنْ في الذاكرة — عامرة بأهلها إلى الأبد.