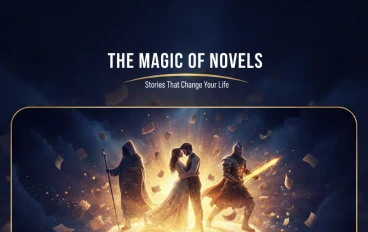"القطار الأخير… تذكرة إلى المجهول"
القطار الاخير الي المجهول
كانت ليلة شتوية ثقيلة، المطر يهطل منذ ساعات بلا توقف، والرياح تعصف بالشوارع كأنها تحمل معها صرخات مجهولة. كنت عائدًا من زيارة صديق قديم يسكن في مدينة تبعد أكثر من ساعتين عن منزلي، ووجدت نفسي مضطرًا للعودة ليلًا رغم الطقس العاصف. لم يكن أمامي سوى خيار واحد… القطار الأخير.
وصلت إلى المحطة قبل منتصف الليل بدقائق، والمعطف يلتصق بجسدي من البلل، وقطرات المطر تنزلق على وجهي البارد. المكان كان شبه مهجور، الصمت يهيمن على كل زاوية، إلا من صوت المطر وهو يرتطم بسقف المحطة المعدني. الإضاءة كانت خافتة، وبعض المصابيح تتأرجح من أثر الرياح، تلقي ظلالًا طويلة على الجدران المهترئة.
الرصيف رقم 3 كان ينتظرني… أو ربما كان ينتظر شيئًا آخر. عليه القطار الأخير، أو بالأحرى ما يشبه القطار الأخير. عرباته قديمة، الطلاء متشقق ومقشر، والزجاج مغطى بطبقة ضبابية من البخار والصقيع. النوافذ مظلمة، وكأنها تخفي ما لا يجب أن يُرى.
اقتربت بخطوات مترددة، وكلما اقتربت أكثر، شعرت بأن الهواء يزداد برودة وكأنني أسير في ممر غير مرئي يفصلني عن العالم الخارجي. صعدت إلى العربة الأولى، فاستقبلتني رائحة عتيقة ممزوجة بالغبار والمعدن الصدئ، تتخللها رائحة أخرى أكثر غرابة… رائحة تشبه الورق المحترق، لكنها أعمق، وكأنها تحمل معها ذاكرة قديمة.
المقاعد كانت متهالكة، بعضها ممزق، وبعضها الآخر مائل كما لو أن أحدًا جلس عليه لسنوات دون أن يتحرك. الأضواء المعلقة في السقف تومض ببطء، تصدر أزيزًا خافتًا وكأنها تحتضر. جلست قرب النافذة، أحاول تجاهل شعوري المريب، وأراقب المطر وهو يتسابق على الزجاج.
لم يكن هناك أي راكب آخر، على الأقل في هذه العربة. وضعت حقيبتي بجانبي، وأغمضت عيني للحظات، لكن صوت خطوات بطيئة، منتظمة، اخترق الصمت. فتحت عيني فرأيت رجلاً طويل القامة، يرتدي معطفًا أسود طويل وقبعة عريضة تخفي وجهه بالكامل. خطواته كانت ثابتة، وكأن كل خطوة محسوبة بعناية. جلس في المقعد المقابل لي مباشرة، دون أن ينطق بكلمة أو يرفع رأسه نحوي.
لمحت في يده تذكرة صفراء باهتة، لونها يوحي بأنها قديمة جدًا، ربما أقدم من القطار نفسه. أصابني الفضول، لكنني لم أجرؤ على سؤاله. تحرك القطار ببطء، لكن شيئًا غريبًا حدث… من النافذة، رأيت المحطة تبتعد، ثم فجأة تعود لتظهر أمامنا من جديد، وكأننا ندور حولها في دائرة مغلقة. المشهد تكرر ثلاث مرات على الأقل، وكل مرة كانت المحطة تبدو أكثر ظلامًا وكأنها تفقد ملامحها تدريجيًا.
قررت كسر الصمت، فقلت:
– "إلى أين يذهب هذا القطار؟"
رفع رأسه ببطء شديد، وكشف عن ابتسامة باردة جعلت قشعريرة تسري في جسدي، ثم قال بصوت أجش، وكأنه يأتي من مسافة بعيدة:
– "إلى حيث يذهب كل من فاته قطاره الأخير… في الحياة."
قبل أن أتمكن من فهم كلامه، بدأ صوت غريب يعلو من الخارج، أشبه بخطوات جماعية بطيئة. نظرت من النافذة، فرأيت أشخاصًا يسيرون بجانب القطار، لكن وجوههم كانت مشوهة، ملامحهم ضبابية وعيونهم فارغة، تحدق في الداخل وكأنها تنتظر إذنًا بالدخول. الغريب أن خطواتهم كانت متزامنة تمامًا مع حركة القطار، وكأنهم ظلّه الحي.
أدرت رأسي نحو الرجل… لكنه لم يكن هناك. المقعد أمامي كان فارغًا، وفوقه تذكرته الصفراء. التقطتها، وعندما قلبتها، شعرت بأن الدم تجمد في عروقي… كان اسمي مكتوبًا عليها بخط واضح وحاد.
قبل أن أستوعب الأمر، انطفأت جميع أضواء القطار دفعة واحدة. الظلام كان كثيفًا لدرجة أنني لم أستطع رؤية يدي أمام وجهي. شعرت بأن القطار توقف فجأة، لكن لم يكن هناك أي صوت… لا مطر، لا محرك، لا حتى أنفاسي كنت أسمعها بوضوح. فجأة، دوّت صفارة بعيدة جدًا، صوتها حزين وممتد، وكأنها تأتي من عالم آخر، ثم حل صمت ثقيل خانق.
حاولت النهوض، لكن قدمي لم تتحركا، وكأن شيئًا ما يمسك بهما. شعرت ببرودة تتسرب من الأرض إلى جسدي، ومعها إحساس غريب بأن هناك من يراقبني عن قرب. سمعت همسات، غير واضحة، تقترب وتبتعد في آن واحد، وكأن مئات الأصوات تتحدث في نفس اللحظة دون أن أفهم كلمة واحدة.
وفجأة، شعرت بيد باردة جدًا تُوضع على كتفي. التفت بسرعة، لكن لم أجد أحدًا. ومع ذلك، كانت تلك اليد ما تزال هناك، تثقل كتفي وكأنها تحاول منعي من الحركة.
ثم… سمعت صوتًا همس في أذني، نفس الصوت الأجش الذي سمعته من الرجل:
– "وصلنا."
في لحظة، شعرت بالأرض تختفي من تحت قدمي، كأن القطار انغمس في فراغ لا نهاية له. كل شيء تحول إلى سواد دامس، لا يوجد فيه زمن ولا مكان، حتى أفكاري بدت وكأنها تتلاشى.
…
في صباح اليوم التالي، روى عامل المحطة أنه رأى القطار الأخير يمر بسرعة ليلًا، لكنه أقسم أن جدول الرحلات لم يكن فيه أي قطار بعد الحادية عشرة مساءً. والأسوأ… أن الرصيف رقم 3 كان مغلقًا منذ أكثر من عشر سنوات، بعد حادثة لم يجرؤ أحد على ذكر تفاصيلها.